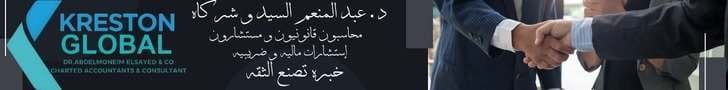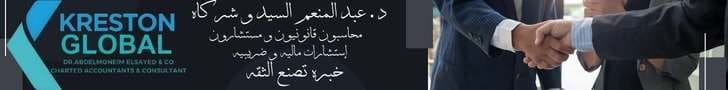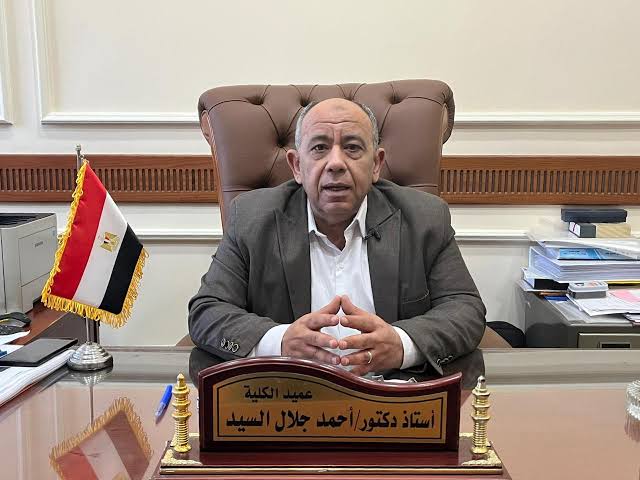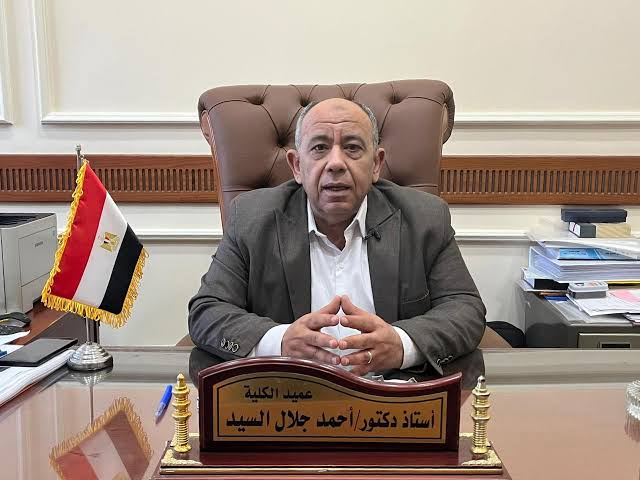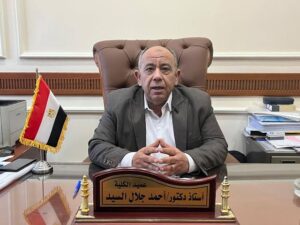في ردهات المدارس الثانوية، لم تعد الجدران وحدها التي تتصدع، بل تتشقق معها قيمٌ وأخلاقٌ كان يُفترض أن تكون الدرع الحامي لمستقبل هذا الوطن. مقاعد تُكسر، أبواب تُخلع، معلمون يُقابلون بتطاولٍ لا يليق بمقامهم، ومشهد الفوضى يطل برأسه كغرابٍ ينذر بعاصفة لا تبقي ولا تذر.
لكن السؤال الملح: هل هؤلاء الفتية جناةٌ يعيثون فسادًا، أم ضحايا بيئةٍ لم تُحسن تربيتهم وتوجيههم؟ أليسوا ثمار شجرةٍ عطشى لم تجد ماء القيم، فضربت جذورها في تربةٍ هشة من إعلامٍ صاخب، وأسرٍ مشغولة، ومناهج أثقلت كاهلهم بالامتحانات وأهملت بناء الإنسان؟
الخطر ليس في حجرٍ يُلقى على نافذة، ولا في سبورةٍ تُخدش بسطورٍ عابثة، إنما في معنى أكبر: إذا انهار جدار المدرسة، فبأي جدار سيتكئ الوطن غدًا؟ وإذا تهاوت هيبة المعلّم، فمن سيعلّم الأجيال القادمة أن للعلم حرمته وللمعرفة مقامها؟
إن المشهد أشبه بسفينة تتمايل على موجٍ هائج؛ فإن لم تتدخل الأيادي المسؤولة سريعًا ـ وزارة التربية والتعليم، الإعلام، الأسرة، مؤسسات المجتمع المدني ـ لتثبيت دفة القيادة، فلن يكون الغرق قدرَ هذا الجيل وحده، بل مستقبل وطنٍ بأكمله.
إنها صرخة تنبيه لا اتهام، جرس إنذار لا جلدٌ للأبناء. فبين مطرقة الضياع وسندان المسؤولية، يقف “جيل حافة الهاوية” منتظرًا من يأخذ بيده قبل أن يسقط في هوةٍ مظلمة، يصعب أن يجد منها طريق العودة.