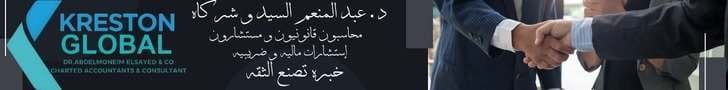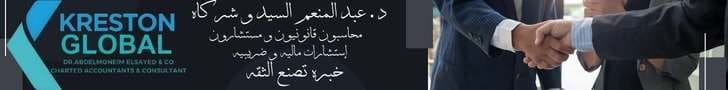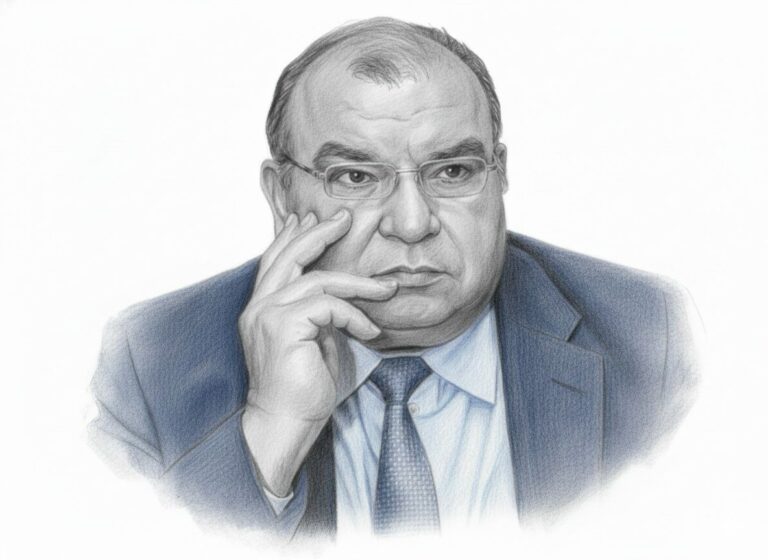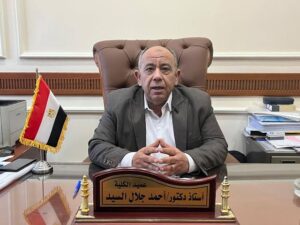تشهد العلاقات الروسية الأمريكية، مرحلة من أكثر مراحلها توتراً منذ نهاية الحرب الباردة، وسط مشهد دولي يتسم بتعدد الأزمات وتشابك المصالح وغياب أطر الثقة المتبادلة. وفي الآونة الأخيرة، تعالت التساؤلات في الأوساط السياسية والدبلوماسية حول ما إذا كانت موسكو وواشنطن تسيران نحو استعادة روح الحرب الباردة، في ظل تصاعد القضايا الخلافية بين الجانبين، وعودة سباق النفوذ إلى واجهة العلاقات الدولية، خاصة مع تجدد الحديث عن إمكانية عقد “قمة المجر” المحتملة لإعادة تنظيم الحوار بين القوتين.
من الواضح أن التوتر بين موسكو وواشنطن لم يعد مقتصراً على الملفات التقليدية كالنووي أو الأمن الأوروبي، بل امتد ليشمل مجالات الطاقة، والمناطق الرمادية، وحتى خطوط النفوذ في نصف الكرة الغربي. ففي الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن نجاح بلاده في اختبار أسلحة نووية متطورة، جاءت الرسالة واضحة للولايات المتحدة وحلفائها بأن روسيا ما زالت تمتلك القدرة على فرض معادلة ردع جديدة، وأنها لن تسمح للغرب بفرض عقوبات أو مواقف أحادية ضدها دون رد.
وبينما اعتبر الكرملين أن هذه التجارب تدخل في إطار الدفاع عن الذات وردع التهديدات، فإنها في واقع الأمر تمثل أداة سياسية تهدف إلى تذكير واشنطن بأن أي تجاهل لموسكو في حسابات الأمن الدولي سيعيد سباق التسلح النووي إلى الواجهة من جديد.
في المقابل، سعت الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، إلى إرسال إشارات مغايرة. فقد أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن الاختبارات النووية التي أمر بها ترامب “لن تتضمن تفجيرات نووية”، في محاولة واضحة لطمأنة المجتمع الدولي وتقليل احتمالات التصعيد.
ومع ذلك، فإن تصريحاته لم تخفف من المخاوف المتزايدة من دخول العالم في مرحلة جديدة من سباق التسلح النووي، خصوصاً في ظل إصرار موسكو على تطوير منظوماتها النووية الهجومية والدفاعية على حد سواء.
اللافت في الأمر أن التوتر بين البلدين لم يعد محصوراً في المجالين العسكري والأمني، بل أخذ طابعاً اقتصادياً واستراتيجياً أوسع. فقد شهدت الأسابيع الأخيرة تحركات لافتة على الساحة الأوروبية، مع سعي رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان للحصول على “مباركة” من ترامب لمواصلة شراء النفط الروسي، رغم العقوبات الغربية.
هذا الموقف يعكس التصدعات داخل المعسكر الغربي نفسه، ويظهر أن موسكو ما تزال قادرة على الاحتفاظ بموطئ قدم قوي في أوروبا عبر تحالفاتها الطاقوية، وهو ما يشكل تحدياً مباشراً لسياسات واشنطن الرامية إلى عزل روسيا اقتصادياً وسياسياً.
وفي الوقت ذاته، يبدو أن الولايات المتحدة وروسيا تتجهان نحو مرحلة جديدة من التنافس في مناطق النفوذ التقليدية خارج أوروبا، لا سيما في أمريكا اللاتينية.
فقد حذرت موسكو واشنطن من “الحشد العسكري غير المبرر” في البحر الكاريبي، ولوّح بعض المسؤولين الروس بإمكانية تزويد فنزويلا بصواريخ باليستية متقدمة. ورغم أن هذا السيناريو يظل بعيداً عن التنفيذ الفعلي، فإنه يعكس رغبة روسيا في إعادة رسم موازين القوى في الفناء الخلفي للولايات المتحدة، في خطوة تحمل رمزية استراتيجية تشبه سياسات الرد بالمثل التي ميزت فترات الصراع بين المعسكرين الشرقي والغربي إبان الحرب الباردة.
وفي ضوء هذه التطورات المتسارعة، يبرز التساؤل الجوهري حول إمكانية تنظيم قمة جديدة بين روسيا والولايات المتحدة في المجر، وسط دعوات أوروبية لاحتواء التوتر المتصاعد. فالقمة، إن عُقدت، قد تمثل فرصة لإعادة ضبط العلاقات، إلا أنها تواجه عقبات كبيرة، أبرزها انعدام الثقة المتبادل، وتضارب أولويات الطرفين، إضافة إلى تصاعد الضغوط الداخلية على كل من بوتين وترامب، ما يجعل أي تنازل سياسي يُنظر إليه كضعف محتمل أمام الخصم.
غير أن القراءة المتأنية للمشهد تشير إلى أن كلا الجانبين يدركان خطورة الانزلاق إلى مواجهة مباشرة، وأن التصعيد الحالي أقرب إلى “توازن الضغط” منه إلى نية الدخول في صدام فعلي. فروسيا، رغم لهجتها الصلبة، تدرك حدود قوتها الاقتصادية في مواجهة الغرب، بينما تعي واشنطن أن فرض مزيد من العقوبات أو الإقدام على خطوات عسكرية سيؤدي إلى توحيد الموقف الروسي-الصيني بشكل أكبر، بما يضر بالمصالح الأمريكية طويلة الأمد.
إن ما تشهده العلاقات الروسية الأمريكية اليوم ليس مجرد أزمة عابرة، بل هو إعادة تشكيل كاملة لبنية النظام الدولي الذي نشأ بعد الحرب الباردة. فالتغيرات المتسارعة في موازين القوى، وتعدد مراكز القرار، وصعود قوى جديدة مثل الصين والهند والبريكس، كلها عوامل تفرض على واشنطن وموسكو إعادة تقييم استراتيجياتهما تجاه العالم. وبينما تحاول الولايات المتحدة استعادة زعامتها الأحادية عبر إعادة التسلح والتحالفات، تسعى روسيا إلى تثبيت موقعها كقوة موازنة قادرة على كبح التمدد الأمريكي، مستفيدة من أزمات الطاقة والتحالفات الإقليمية.
في النهاية، يمكن القول إننا أمام مرحلة جديدة من “الحرب الباردة المرنة”، تختلف في أدواتها لكنها تتشابه في جوهرها مع الصراع القديم: تنافس على النفوذ، واستعراض للقوة، وتبادل للرسائل الردعية، مع حرص متبادل على تجنب الانزلاق إلى مواجهة شاملة.
وربما تكون قمة المجر – إن تمت – فرصة لاختبار مدى استعداد الطرفين للعودة إلى لغة الحوار، بدلاً من العودة إلى سباق الردع النووي الذي يهدد بإعادة عقارب الساعة إلى حقبة كان العالم يظن أنه تجاوزها إلى غير رجعة.